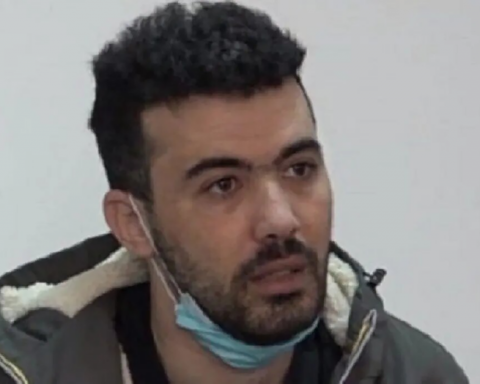بقلم: د. يوسف بجاوي، عضو حركة رشاد
أصدرت التنسيقية الجزائرية لأنصار المشروع الوطني بيانًا سوّقته وسائل إعلام الجنرالات على أنه دعمٌ من النخبة الفكرية لمشروع الانتخابات الرئاسية التي يعتزمون تنظيمها في 12 ديسمبر القادم. وجاء هذا البيان بعد يومين من بيانٍ مماثلٍ صدر عن جمعية العلماء، استغلته وسائل الإعلام باعتباره شرعنة دينية للانتخابات الرئاسية. ووقّع على البيان العشرات من الأساتذة والدكاترة، أغلبهم من أبناء الوطن المخلصين الذين قدّموا الكثير لبلدهم، غير أنّ فيهم بعض المتسلّقين والنرجسيين المعروفين بأنشطتهم التخريبية للحراك. وتندرج الملاحظات أدناه في باب التناصح بين إخوة وزملاء.
يبدأ بيان التنسيقية بالعموميات حيث يعلن الموقّعون عن وطنيّتهم وقِيَمهم السياسية التي تضم دعمهم للحراك وإدانتهم للسجلّ الكارثي لـ”نظام الحكم”. وهذا أمرٌ جميل.
ما يُثير القلق في هذا البيان ويستدعي التعليق النقدي هو دعمه لمشروع قيادة الأركان لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل.
يبدو أنّ مصدر هذا الدعم هو الخوف أو التخوّف أساسًا لأنّ الموقعين على البيان يؤكّدون أنّ هذا الطريق سيجنّب البلاد “انزلاقات أو مغامرات”. والأساتذة والدكاترة الذين تبنّوا هذا الدعم لم يقدّموا حججًا عقلانية لموقفهم أو أدلّة تجريبية مشتقّة من الدراسات المقارنة للتحوّلات الديمقراطية تعزّزه (1). من المؤكد أنّ دعاة الحوار الوطني والعملية التأسيسية لجمهورية جديدة في فترة انتقالية قبل الانتخابات الرئاسية قدّموا مجموعة واسعة من الحجج – وأهمّها أنّ أيّ رئيس منتخب سيرث سلطة إمبراطورية بموجب الدستور الحالي الذي ينتهك مبدأي الفصل وتوازن السلطات – لكن البيان الصادر عن هذه التنسيقية يتجاهلهما تمامًا.
طبعًا لهذه التنسيقية الحق في تجاهل حجج دعاة التأسيس قبل الترئيس، لكن كيف لها أن تتجاهل صوت الحراك، الذي يصرخ ويغني منذ الصيف أنه “ما كانش انتخابات مع العصابات”، وهي تدّعي أنها أسّست أصلًا لتحقيق أهداف الحراك. أليس هناك تناقض بين دعم مشروع الانتخابات في الظروف الحالية والزعم بالتمسّك بمطالب الحراك؟
قد يردّ أعضاء التنسيقية أنهم لا يتناقضون بل يريدون “تحقيق مطالب الحراك بشكل واقعي، عقلاني وتدريجي”، كما جاء في نصّ البيان، ممّا يوحي ضمنيًا أنهم يعتقدون أنّ الحراك يقارب أهدافه بطريقة وهمية أو رومانسية وغير عقلانية ومتهوّرة.
لنتأمّل بدايةً في زعم عقلانية المقاربة التي تنتهجها التنسيقية. بعيدًا عن كونه غير عقلاني، فإنّ الرفض القاطع لانتخابات ديسمبر من قِبل الحراك له ما يبرّره. فمعلوم أنّ الانتخابات توجّه رسائل بشكل عمودي، من الناخبين إلى الأحزاب والحكومة، كما هي أداة الشعب لمساءلة الحكام الذين عادة ما يعدّلون سياساتهم وفقًا لتطلّعات الناخبين، خوفًا من معاقبتهم في صناديق الاقتراع، ممّا يؤدّي إلى التوافق بين الدولة والمجتمع. أمّا في الجزائر ومنذ الاستقلال فلم تخرج البلاد من الانتخابات التصفيقية في عهد “الاشتراكية الجزائرية” إلا لتغرق في الانتخابات المزوّرة في عهد ديمقراطية الواجهة. فالجزائريون في الحراك يفهمون جيّدًا وظيفة الانتخابات التواصلية وما ينطوي عليه تقطّع هذا التواصل من صمم الحكام واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع. فأكيد أنّ التنسيقية سمعت شعار الحراك الذي يقول: “بما أنّ أصواتنا لا تصل إلى وسائل الإعلام، فكيف لها أن تصل إلى صناديق الاقتراع؟”
إذا كان هناك نقص في العقلانية، فإنه يكمن في ثقة موقّعي البيان في السلطة “المستقلة” لتنظيم الانتخابات وليس في رفضها من قِبل الحراك. لقد أُنشئت هذه السلطة خارج إطار الدستور، وشُكّلت بسرعة السير العسكري، كما يُديرها ويُهيمن عليها زبائن فاسدون من نظام بوتفليقة. ومن شأن أيّ قراءة متأنّية للنصوص التي تقنّن أشغال هذه السلطة أن تُقنع أيّ عاقل أنه من المستحيل أن تتمكّن هذه السلطة من بناء هيكلها ثم تنظيم ومراقبة انتخابات تشمل 60.000 مركز اقتراع، في المواعيد المرتقبة.
طبعًا، فيما يخصّ إدارة العملية الانتخابية من قِبل هذه السلطة، أعرب موقّعو البيان عن رغبتهم في إدراج كفاءات صادقة واستبعاد المسؤولين عن التزوير في الانتخابية السابقة، وذلك من أجل تحقيق الشفافية، كما أعربوا عن رغبتهم في فتح مجال الإعلام للسماح للآراء المختلفة بالتعبير عن مواقفها. وهذا أمرٌ جيّد بالطبع، لكن يبقى مجرّد رغبات لا تُلزم أحدًا، لأنّ الموَقعين على البيان لم يشترطون صراحةً دعمهم للانتخابات الرئاسية بتطبيق هذه الإجراءات.
كان ينبغي أن تكون هذه الرغبات شروطًا إلزامية، أو بالأحرى جزءًا فقط من الشروط التي يجب تلبيتها قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية. هذه هي العقلانية الحقيقية. لا يمكن اعتبار الانتخابات المزمع تنظيمها انتخابات حرّة والشعب يشتكي من الاعتقالات التعسفية وسجن الناشطين السياسيين والمضايقات القضائية والحصار المفروض على العاصمة إلخ. وبدلًا من تدابيرٍ لتهدئة المواطنين واسترضائهم، فإنّ حريات الحركة وتكوين الجمعيات والتجمّع والتعبير هي التي تتعرّض للهجوم. ولكي تكون الانتخابات نزيهة، يجب أن يكون هناك قضاء مستقل للتحكيم بشكل منصف في أيّ نزاع محتمل، بالإضافة إلى تحرير وسائل الإعلام. لقد ظلّ الشعب الجزائري يقول بصوتٍ عالٍ وواضحٍ منذ شهور أنه لا يريد انتخابات في ظل “العصابات”، بمعنى المسؤولين المدنيين والعسكريين الفاسدين المفسدين، إضافة إلى القوات والشبكات غير الدستورية التي تقرّر وتناور في الخفاء. ومن أقوى هذه العصابات المخابرات أو البوليس السياسي، وهي الذراع المسلّح والسياسي الذي من خلاله يتلاعب بعض قادة الجيش بالطبقة السياسية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، وبواسطته يتمّ تخويف الشعب. وهذه العصابة الضارة لا تزال محمية حتى يومنا هذا. فطالما لم يتمّ تفكيك آلة الرعب هذه، الخارجة عن إطار الدستور، لا يمكن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة في البلاد.
رأينا أعلاه أنّ التنسيقية تزعم أنها تريد “تحقيق مطالب الحراك بشكل واقعي، عقلاني وتدريجي”، فلنتأمّل الآن في زعم تدريجية المقاربة التي تنتهجها. فالحراك موافق أنه يستحيل استبدال نظام فاسد بنظام ديمقراطي على الفور، فهذه العملية هي عملية تدريجية، والمرحلة التي يتمّ فيها استبدال النظام الفاسد بنظام ديمقراطي تسمّى التحوّل أو العبور أو الانتقال الديمقراطي. ولا يمكن أن يحدث الانتقال الديمقراطي فورًا لأنه لا يتطلّب استبدال مجموعة من الأشخاص بمجموعة أخرى فحسب، بل يقتضي تفكيك أسوأ تركات النظام البائد، من ناحية، ويتطلّب وضع أسس النظام الديمقراطي الحقيقي، من ناحية أخرى. إنّ التحوّل الديمقراطي هو عملية تقتضي عدة أمور من بينها وضع المؤسسات السياسية التي ستدير عملية الانتقال، ومراجعة الدستور وسنّ قوانين النظام السياسي الجديد لضمان انفصال السلطات وتوازنها، وتصحيح القوانين والهيئات وعمل العدالة لضمان استقلاليتها، وإصلاح القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات لضمان الممارسة الحرة للعمل السياسي والاجتماعي، ومراجعة القوانين والمؤسسات والإجراءات لضمان انتخابات حرّة ونزيهة وخالية من التزوير، ومراجعة القوانين وإنشاء هيئات تضمن نشاط إعلامي حرّ ومسؤول، وكذا إصلاح القطاع الأمني حتى يتماشى مع النظام الديمقراطي الجديد. باختصار، فالتنسيقية التي تدعم تهوّر قيادة الأركان في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال هي التي تنتهك مبدأ التدرج في التغيير، وليس الحراك.
تزعم التنسيقية أنها تريد “تحقيق مطالب الحراك بشكل واقعي، عقلاني وتدريجي”، فلنتأمّل أخيرًا في زعم واقعية المقاربة التي تنتهجها. إذا كانت الواقعية شكلًا من أشكال السخرية (Cynisme)، أو المثالية المهزومة، أو تشويه الواقع، أو الهروب من المسؤولية، أو الثقة في السلطة، أو فلسفة تتصوّر الجزائر من خلال عيون بعض الجنرالات مثل القايد صالح، فنَعَم الحراك غير واقعي. يقول ألدوس هكسلي (Aldous Huxley) أنّ “الواقعية الساخرة هي أفضل عذر للرجل الذكي كي لا يفعل شيئًا في موقف لا يُطاق”. إنّ الواقعية الحقيقية هي الإدراك أنّ كل فعل يغيّر العالم، والواقعية الحقيقية هي كلّ ما يُلقي الضوء على ما هو بين التغيير والتحدي، والواقعية الحقيقية تُدرك أنّ إنقاذ الجزائر يتطلّب مشاركة الشعب بأكمله سياسيًا في هذه المهمّة ولا يُمكن أن يتمّ من خلال زعيم منتظر اختاره الجيش.
ليس من السذاجة التطلّع إلى ثورة ديمقراطية، بل هو أكثر واقعية اليوم من تقاعس “الواقعيين” المدمّر. صحيحٌ أنّ هناك لحظات في التاريخ يخسر فيها الثوار الرومانسيون كل شيء بانتهاجهم طرق مسدودة الآفاق. لكن هناك أيضًا لحظات تكون فيها الشعوب موحّدة في طلب التغيير العميق وينكمش فيها الطغاة وتتقدّم الحرية، فتأتي بفرصٍ حقيقية للنجاح. وهذه اللحظات التأسيسية في تاريخ الأمم لا يصنعها متخصّصو “الواقعية” بل تكتبها جراءة وعبقريّة الشعوب.
ليس الحراك الجزائري بصنيع الدكاترة أو الأساتذة، أو الفنانين أو الكُتّاب أو حتى الطُلّاب، ناهيك عن الأئمة أو السياسيين. لقد أحدثه الشباب المنفي في بلاده، الشباب الذي جعل من الملاعب ملاذًا للجزائر الحرّة والكريمة لمّا كانت بقية البلاد تتكيّف مع أسوأ تجاوزات إرهاب الدولة والفساد المالي والسياسي. إحدى أغاني هذا الشباب تقول أنّ “الحرية، الحرية، الحرية لا تخيفنا”. لم تجذب هذه الكلمات الغريبة والمفاجئة انتباه أيّ صحفي أو دكتور أو أستاذ. هل هناك من يخاف من الحرية؟
من الواضح أنّ الطاغية يخاف من حرية المستضعفين، لكن هل يخاف بعض المستضعفين من الحرية ويفضلون البقاء بقيودهم؟ الجواب نعم.
بالطبع لا أقصد هنا رابطة الأسر أو متلازمة ستوكهولم (Syndrome de Stockholm) عند ضحايا إرهاب الدولة، أي الظاهرة النفسية التي لوحظت لدى المختطفين الذين عاشوا لفترة طويلة مع سجّانيهم بحيث يُبدون التعاطف والانسجام معهم والولاء لهم، نتيجةً لآليات نفسية معقّدة للتماثل وللدفاع عن الذات.
فالمقصود هنا هو الخوف من ممارسة الحرية وتولّيها، والخوف من حمل أعباء مسؤولياتها، والارتباك من اتخاذ الخيارات، والقلق من التساؤلات، والتخوّف من تولّي المصير، والحيرة من غموض المستقبل في ظل الحرية. وحسب إريك فروم (Erich Fromm) المختصّ في علم النفس الاجتماعي والذي درس المجتمعات القابعة تحت حكم شمولي أو مستبد، هناك مفارقة إنسانية تتمثّل في التطلّع إلى الحرية، من ناحية، والشعور بالأمان في ظل الحكم الاستبدادي، من ناحية أخرى. ويقول فروم أنه من الخطأ الاعتقاد أنّ في هذه مجتمعات كلّ الناس يطمحون إلى الحرية، فهناك من الشعب من يخافها ويفرّ منها. وهناك من يجد انعدام الحرية مُريحًا لأنّ ذلك يعطي بنية لحياته، ويعفيه من اتخاذ الخيارات ويجنّبه الشكوك ويعطيه يقين المستقبل كما يمنحه مكانة اجتماعية معترف بها. ويعتبر فروم أنّ الذين يخافون من الحرية يفرّون منها من خلال ثلاث آليات: 1) عن طريق التسلّطية أي بالاندماج في التسلسل الهرمي الاجتماعي الاستبدادي حتى يصبحوا جزءًا من النظام الاستبدادي، أو 2) عن طريق التدمير الذاتي (الوحشية، الجريمة، الإرهاب)، أو 3) بالتوافقية (Conformisme) أو التخفّي (Anonymat) عن طريق الذوَبان في الجمهور.
لقد أدّت حتما عقودٌ من الديكتاتورية العسكرية والاشتراكية واقتصاد الريع وممارسات الزبونية السياسية إلى إنتاج أناس يخافون من الحرية. فبدلًا من إعطاء دروس عن العقلانية والواقعية والتدريجية للحراك، من الأفضل أن يقوم بعض أعضاء التنسيقية الجزائرية من أنصار المشروع الوطني بالتأمّل في مفارقة القهر هذه التي تهمّهم أيضًا، وقد يقنع ذلك البعض على عدم عرقلة حركة التحرّر الوطني بالأبوية السياسية.
علاوة على ذلك، ينتظر الشعب من دكاترته وأساتذته عدم المزايدات الهوياتية، وعدم تأجيج خطاب النوفميرية والباديسية الأيديولوجي الذي أحدثته ثعابين الدولة العميقة لتقسيم الشعب الجزائري. ولتتذكر هذه النخبة أنّ فرصة الجزائر الأولى للانتقال الديمقراطي ما بين 1989 و 1991 أُجهِضت لما ارتمى جزءٌ من التيار العلماني في أحضان العسكر، بعدما أقنعه سحرة الدولة العميقة وتُجّار الخوف أنّ التيار الإسلامي هو الغول وأنّ العسكر هم السدّ الواقي والحصن المنيع ضد هذا التهديد. فلتنتبه هذه النخبة لأنّ نفس الأجهزة تجتهد اليوم لإجهاض هذه الفرصة الثانية للانتقال الديمقراطي بمحاولة رمي جزءٍ من التيار الإسلامي والوطني في أحضان العسكر، إذا تمكّن كهنة الدولة العميقة وتُجّار الخوف ونظريات المؤامرة من صنع وغرس وتضخيم صورة البورورو الزوافي–العلماني–الفرنكو–صهيوني في المخيلة الجماعية ومن تسويق خرافة أنّ العسكر هم السدّ الأخير ضد هذا الخطر المفبرك. جزائر الشعب تعيش وقت الفرص وليس وقت الخوف، فلا خوف إلّا من الخوف ذاته.
ما ينتظره الشعب الجزائري من كلّ هذه الكفاءات هو بحوث ودراسات ومنشورات حول كيفية تعديل الدستور لضمان الفصل بين السلطات الثلاثة وتوازنها، وحول القوانين والإصلاحات التي يجب توفيرها لإرساء أسس دائمة لاستقلال القضاء، وعن التعديلات الدستورية والقوانين والآليات التنظيمية والإجراءات الدقيقة الأخرى التي يجب وضعها من أجل تمكين الحكومات المدنية المنتخبة من التحكّم الديمقراطي في الجيش وكذا مراقبته من طرف برلمان شرعي، وحول كيفية إصلاح أجهزة المخابرات، وحول القوانين والآليات والإجراءات التي يجب وضعها لضمان إعلام حرّ ومسؤول ومستديم، وعن الخطوات التي يمكن اتخاذها للقضاء على الفساد المالي والسياسي، وحول كيفية استرجاع الجزائر لتأثيرها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مسائل أساسية أخرى فيما يخصّ الخروج من الاقتصاد الريعي وتأسيس اقتصاد ناجح، والتعليم، والصحة، والعمران، إلخ.
“ما كانش انتخابات مع العصابات”، هي حكمة الشعب وعين الواقعية والعقلانية والتدرّج.
هامش (1) الملاحَظ تجريبيًا هو أنّ التحوّلات الديمقراطية التي تتمّ في الإطار الدستوري يجري التلاعب بها لحماية النخب الحاكمة من سيادة القانون أو لمنحهم تفوّقًا في المنافسة السياسية بعد عملية الدمقرطة. نعلم أنّ حوالي ثلثي البلدان التي تبنّت الديمقراطية منذ الحرب العالمية الثانية قد فعلت ذلك بموجب دساتير وضعها النظام السلطوي المخلوع (مثلا كينيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وتشيلي والمكسيك). وما تبيّنه دراسات هذه التحوّلات هو أنّ الأدوات الدستورية يتمّ التلاعب بها من قِبل النخب الاستبدادية المُزاحة لتوزيع السلطة والامتيازات لصالحها، وذلك من خلال تصميم النظام الانتخابي، والتعيينات التشريعية، وقوانين العفو الشامل، ودور الجيش في السياسة، وهندسة المحاكم الدستورية. ومن المعروف أيضًا أنّ هذه النخب تضع عقبات أمام تعديل العقد الاجتماعي، من خلال إجراءات دستورية تفرض عتبات التغيير بالأغلبية المطلقة وتعزّز بذلك مزاياها.