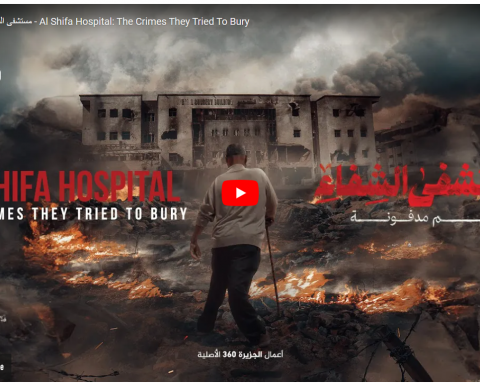الرئيس بن يوسف بن خدة في 1 نوفمبر 1984
في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى الثلاثني لفاتح نوفمبر 1954م، من الواجب على كل مواطن أن يلقي نظرة على المرحلة التي قطعناها منذ ذلك التاريخ وأن يطرح على نفسه الأسئلة التالية:
ما هي الدروس والعبر التي ننستخلصها من حرب التحرير؟
ما هو الحكم الذي يصدر في شأن الاختيار الاشتراكي ونظام الحزب الواحد الذي يسيرنا منذ ثلاثين سنة؟ وما هي الحصيلة؟
ما هو أفضل منهد يجب اتخاطه لتخلص الجزائر من التخلف؟
حرب التحرير والدروس المستخلصة منها:
لم يكن أول نوفمبر 1954 حدثا مفاجئا أو ظاهرة ناجمة عن الصدفة، بل كان آخر مرحلة وبداية مرحلة أخرى، فهو نتيجة عمل طويل وشاق تطلب ثلاثين سنة من الجهد والتفاني لا حد لهما من أجل التوعية والوطنية وتنظيم الشعب، فيه بداية ثورة شعب من أجل استقلاله دامت أقرب من ثمان سنوات أسفرت عن تضحيات جسام مادية وبشرية سقط خلالها النخبة من أبنائه. وفي سنة 1962م حققت الجزائر استقلالها التام واستعادت سيادتها الوطنية داخل البلاد وخارجها، وتتمتع بالتسيير والإشراف على ثرواتها الاقتصادية، وتملك الحرية الكاملة في أن تختار المنهج الذي تريده والنظام الاجتماعي والاقتصادي الذي ترضاه. أما مشكلة الأقلية الفرنسية – عددها مليون نسمة – التي تكاد تشكل للبلد وضعية شبيهة بوضعية لبنان حيث الأقلية تعاكس قرار الأغلبية، وهذا بسبب رفضها الدائم وتعنتها المستمر لمبدأ استقلال الجزائر، إلا أن هذا الخطر أبعد نهائيا بما يحفظ الأجيال القادمة من النزاعات بين المجموعتين.
لقد أوشك أن يكون الاستقلال ناقصا لولا حصولنا على وحدة التراب. فنحن لم نرث بلدا مجزءا أو مبتور الأعضاء، بل ورثنا ارضا متماسكة الأجزاء بدءا من شواطئها المتاخمة للبجر المتوسط إلى حدودها الصحراوية، هذه الصحراء التي هي ضمان مستقبلنا الصناعي والتي ضمنت حتى الآن معيشتنا بفضل الله الذي من علينا بالتبرول والغار.
وهذا النصر المزدوج الذي حصلت عليه الجزائر من ساتقلالها ووحدة ترابها له عوامل ثلاثة:
1 – وطنية تدعمها العقيدة الإسلامية التي كانت تبعث على الدوام روح المقاومة في نفس الجماهير في جهادها ضد المحتل.
2 – وحدة الصف وتضامن الشعب حيث شارك بكل فئاته في المعركة.
3أداة الكفاح التي تتمثل في جبهة التحرير الوطني وهي عبارة عن تجمع بين أحزاب ومنظمات إسلاميةكحزب الشعب الجزائري، حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وجمعية العلماء، والطرقية وهلم جرا… هذه الجبهة التي كان مؤسسوها أعضاء من حزب الشعب – حركة الانتصار للحريات الديمقراطية – والتي أثببت وجودها كممثل وحيد للمقاومة الجزائرية.
إلا أن هذه الوحدة لم يكتب لها – وللأسف الشديد – البقاء بعد الاستقلال، ومرد ذلك إلى الجبهة التي كانت لها نقائص نذكر منها الأهم، حيث يجب أن نعرفه بالخصوص للشبيبة التي نشأت في جهل وتزييف وقائع الأحداث التاريخية للثورة.
إن الجماهير الشعبية هي التي دفعت ضريبة الدم أثناء الحرب وفرضت على العدو وقف إطلاق النار أولا والسيادة الوطنية ثانيا، كان حافزها الأساسي الجهاد، وإن لم يكن في قدرتها التعبير عما يحتويه الجهاد من مفاهيم اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. أما أولئك الذي قادوا المعركة – وهم متواجدون في الخارج – فكانوا متأثرين في الإجمال بالثقافة الأوربية، وكانوا يؤمنون بالاشتراكية وفضائلها عن حسن نية، ولكن لم يجروا عليها مسبقا تحليلات ولم يتعمقوا في معانيها ولم يقارنوا بينها وبين الإسلام الذي هو أساس هويتنا الثقافية وضميرنا الوطني. فهنا انعكس التخلف الثقافي الذي كانت فيه البلاد غارقة إبان الاستعمار، وهذا ما كان قد أحدث فجوة وتناقضا داخل الثورة بين القمة والقاعدة، وهذا التناقض الذي ما كان ليبرز أثناء حرب التحرير بفضل حكمة وتبصر الجهبة التي عرفت كيف تتفادى أو تقاوم الخلافاتالفكرية الداخلية، وظهر غداة الاستقلال واضحا جليا.ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ازداد تأزما وخطورة بسبب الأهواء والطموحات الخاصة كالسعي وراء الحكم عند البعض.
أما الانقلاب الذي حيك ضد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عام 1962م وتسبب في تحطيم وحدة جبهة التحرير الوطني فإنه كان طعنة قاضية على شرعية الحكم وسابقة لانقلاب 19 جوان 1965م، وبالرغم من هذين الانقلابين لم تجد الأزمة حلها، بل اشتدت حدتها وفتحت الباب للانتهازيين والمغامرين وأصحاب المذاهب الأجنبية الهدامة الممثلة من طرف اليسارية والماركسية، وسمحت لهم بالتسرب داخل هياكل الدولة والحزب، وبالتسلل إلى مراكز القرار والنفوذ من السيطرة على مراقبة أجهزة مصالحها الحيوية، ومن هنا بدأ انحراف الثورة.
الاختيار الاشتراكي والحزب الواحد:
أحدث الاختيار الاشتراكي المتفق عليه من طرف مؤتمر طرابلس في شهر جوان 1962 والذي تبناه ميثاق الجزائر العاصمة عام 1964 أحدث وضعية خطيرة أخرى عندما قرر الميثاق الوطني 1976 أن ينتقل من الاشتراكية إلى اشتراكية قاعدتها « العلم »، والكل يعلم أن الاشتراكية التي قاعدتها العلم ما هي في الواقع إلا مرادف لت « الاشتراكية العلمية »، والتي هي الماركسية الينينية بعينها. فهي تختلف تمام الاختلاف مع واقعنا الوطني العميس الذي أساسه الإسلام.
فالاشتراكية العلمية تنظر للإنسان بمنظار مادي، إذ أنها تدعو بصراحة إلى صراع الطبقات. فتحريمها للملكية الخاصة ووسائل الإنتاج والتبادل التجاري وتحويلها إلى الدولة يرجع لا أكثر ولا اقل إلى تحويلها لبيروقراطية محتكرة للحكم وللثروات، ولوسائل الفكر والتعبير، كما هي لا ترضى باي اعتراض مهما كان نوعه. وأما الإسلام فينظر للإنسان نظرة شاملة بجانبينها المادي والروحي، ويدعو إلى الأخوة بين الناس، فوضع نظاما مبنيا على الأخلاق والفضيلة كما جعل للملكية الخاصة ذات الاستغلال الفاحش حدودا مع مراعاة حياة المستضعفين، وهذا بفضل نظام اجتماعي قاعدته الزكاة ومؤسسات خيرية أخرى.
ومن الواجب علينا أن تعترف بأخطائنا –كل ابن آدم خطاء – فاجتماع طرابلس عندما قرر مبدأ الحزب الواحد، كان في نوايا أعضاء المجلس –باتخاذهم هذا القرار- توحيد الصف وغبقاء الشعب مجندا من أجل معركة النمو والتطور، تحت قيادة حزب واحد ألا وهو : جبهة التحرير الوطني، كما كان الحال ايام حرب التحريرن لكن وياللاسف فبمجرد الإعلان عن الاستقلال انقلبت الجمهورية الجزائرية إلى ديكتاتورية الحزب الواحد الذي تدهور رويدا رويدا فأصبح دكتاتورية وجل واحد خاصة تحت حكم الرئيس الراحل. فكل من سولت له نفسه أن يعبر عن فكرة تناهض رأيه وجد نفسه مهددا لا في حياته فحسب بل وحتى في ممتلكاته وأسرته، وأسباب معيشته، فقد جمع السلطات كلها بين يديه فهو الواحد الذي يقرر اختيارات البلاد ويتصرف في ثرواتها وميزانيتها،ن كما يتحكم في الرقاب، ويعلن الحرب مثلما يعلن السلم، فله الحق وحده في أن يدفع بالشعب أو الجيش في هذا أو ذلك الميدان، فسقط من جديد فيما يسمى « تقديس الشخصية » التي كان يزعم محاربتها عندما قام بانقلاب 19 جوان 1965 ضد سلفه.
ففي عهده انتخب الميثاق الوطني بـ %98,51 وهو المرجع الوحيد لقوانيننا، وهذا الميثاق يقوم الإنسان لا على حسب مقاييسه الإنسانية والخلقية،ن بل على حسب مردوده المادي.
تركة ثقيلة مرهقة:
إنها تركة ثقيلة تركها الرئيس الراحل للأمة غداة وفاته سنة 1978 بعد مضي ثلاثة عشر عاما من الحكم المطلق.
حقا ليس من الإنصاف أن نتجاهل ما أنجزه الفقيد من بناء مدارس وثانويات وجامعات ومصانع، وفتح الطرقات، ووضع شبكات المياه والغاز والكهرباء والسكن، وتوسيع المواصلات. وقد واصلت الحكومة الحالية هذه الإنجازات في شتى الميادين، ويبدو أنها تفضل العودة إلى الأرض وإعطاء الفلاحة الاسبقية على حساب الصناعة، كما تفكر في تشجيع أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقد بذلت أيضا أموالا طائلة لسد العجز في مجال السكن، كما نالت شبكات المواصلات كالطرق والجسور والسدود وهمل جر دفعا جديدا من طرف السلطة، وبدأت « الصرامة » تعطي ثمارها في التسيير، غلا أنه لا تزال على السبورة نقاط سوداء.
فالفلاحة والصناعة وهما المحوران الأساسيان للاقتصاد الوطني والصحة وأهميتها، فكل هذه القطاعات الهام قد باءت بالفشل والخيبة. أما قضية الشباب وتوجيهه الصحيح فلا زالت محل الاهتمام الكبير. وأما أحوال الأسرة الجزائرية التي تعتبر الخلية الأولى للأمة فقد أصيبت برجة عنيفة في صميم كيانها والتي ازدادت خطورة بسبب وسائل الإعلام التي تتصرف فيها الدولة كالصحف والإذاعة وخاصة التلفزة عندما دخلت هذه جل البيوت، فقد أحدثت تقلبات جذرية في التقاليد والعادات بعرضها على الشاشة الصغيرة حصصا وبرامج تتنافى في غالب الأحيان مع قيمنا وأخلاقنا الإسلامية، زيادة على ما تبثه من الدعايات التي كان من نتائجها المؤلمة تعطيل الفكر وانحطاط المستوى الثقافي والخلقي للمواطن.
أما نظام التعليم وإن يكن قد شمل أكبر عدد من الناس – خمسة ملايين من طلاب وتلامذة – فإنه لم يعط المواطن تكوينا جيدا يجعله يشعر بمسؤولياته، قادرا على مواجهة الصعاب، قائما بالأعمال التي يمليها عليه الواجب من أجل بناء صرح أم حديثة، وهذا الخلل الملحوظ يعود إلى الهياكل السياسية المرتبطة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية، والمنصوص عليها في الميثاق الوطني، رغم أنها لا تتجاوب لا مع حاجات البلاد ولا مع قضايا الساعة، كما أنها لا تتفق مع أماني الأمة ورغباتها. فهم حكم فردي يرتكز على الحزب القائم على اختيارات لا تبديل ولا تغيير فيها (لا رجعة فيها).
فالشعب لا يملك حق المشاركة من أجل تحديد مصيره بيده، فهو ينظر نظرة لا مبالاة إلى مسائل التنمية كأنه لا يشعر بها، وكأن هذه المسائل لا تهمه بعد أن أبعد عنها، فلا هو يراقب الحكومة ولا هو يعبر عن فكرته بكل حرية، ولا برأيه عما يحيط بتسيير شؤون الدولة، فقد وجد بعض المواطنين الذين جرؤوا على إنقاذ بعض جوانب سياسة الحكومة، وجدوا أنفسهم في غياهب السجن، منهم من قاسى الألم والتعذيب ما لا يجرؤ عليه إلا المستعمر.
نعم فمن الواضح أن البديل ليس هو اتخاذ النظام الرأسمالي الذي يجتاز مرحلة مظفرة له داخل المجتمعات الاستهلاكية، حيث تصوراته لتكديس المال وجهوده من أجل الهيمنة الاقتصادية تأتي حتما بالقضاء على الضعفاء وعدم احترام كرامة الإنسان، ولهذا النظام نفس المقاييس كالاشتراكية: الرفاهية المادية وعدم الإيمان بالروحانيات والغاية السامية، فالدول العربية في الخليج التي اختارت الرأسمالية كمنهج لنموها لم تحرز على تقدم ولا على استقلال أحسن من الدول الأخرى التي تبنت المنهج الاشتراكي.
لقد كنا جميعا ضحيا للغزو الفكري الوافد من الغرب حيث زاد في التخلف الذي يتخبط فيه المجتمع الإسلامي منذ قرون عديدة.
البحث عن منهج خاص بنا للتطور:
منهج التطور هو قبل كل شيء اختيار مذهب لبناء مجتمع. وحد الآن فكل ما أنجزناه ما هو إلا خبطة عشوائية إن لم تكن القهقرى لأنه لم يكن من عملنا سوى تقليد الشرق أو الغرب، فمن الأول اقتبسنا أساليب الحكم الاستبدادي والحزب الواحد ومن الثاني أخذنا نمط حياة المجتمع الاستهلاكي، وهو فرعان منبثقان من جذع واحد ألا وهو الجذع الأوروبي الذي يرجح الجانب المادي على الجانب الروحي، ويقصى حكم الله في شؤون الأمة، وعلاوة على هذا فكلاهما مسير من طرف دولتين إمبرياليتين تتقاسمان العالم ومتنافستين، وغرضهما الوحيد إبقاؤنا على الدوام في حالة تبعية مستمرة لهما، فحالة العالم الإسلامي المفتت الذي أصبح فريسة يتنازعه الشرق والغرب بشراسة والذ انقسم إلى دول متعادية وأحيانا متحاربة، بعضها في فلك الروس والآخر في مدار الأمريكان، لهو منظر مؤلم وموسف، وإذا توجهنا نحو المغرب العربي بالخصوص يتضح أن هناك مناورا تحيكها الدول الأجنبية التي تسعى إلى إنشاء كتلتين متنازعيتن على حساب شعوب المنطقة التي ترغب في الوحدة وحسن الجوار.
فإذا أردنا أن ننقذ الجزائر من عبودية جديدة الشكل أو بعبارة أوضح، من استعمار جديد ألا وهو غزو فكري هذه المرة –قد كان روسيا أو غربيا – حيث تقع بلادنا فريسة للنهب والسلب والاحتلال الأجنبي، فلنرجع إلى رشدنا، إلى منابع فكرنا، إلى حقيقة أصالتنا، دون أن نغلق الباب في وجه العالم المعاصر. فعلينا إذن أن نبحث عن منهج خاص بنا للنمو وإن كان علينا إبداعه، فعلينا أن نستقرئ الإسلام ونستخلص منه مبادئ الفكر والعمل. إنه دين يشجع المبادرة الفردية في الإنتاج ويحمي مصالح الجماعة، يحرم احتكار الثروة من طرف الأقلية الغنية، ويقضي على دعوى فضل طبقة أو عرق أو جهة معينة، فالإسلام يدعو إلى الأخوة والمساواة بين الناس والتسامح والعدالة الاجتماعية، وحب العمل، فهو يحمي الإنسان من طغيان الدولة واستبداد الملوك – متوجين أو غير متوجين – ويحرر من خول جبروتهم.
إذ أنه يحمي الأسرة من التفكك والانحلال الخلقي ومن الآفات الاجتماعية التي تنجر عنها، ويوفق بين العقيدة والعلم. فلا يوجد أحسن منه للمحافظة على أصالتنا فهو أنجع عامل للتعريب،وهذا بفضل القرآن الكريم، وخلاصة القول أنالإسلام هو الركن الركين للوحدة الوطنية وتعبئة الجماهيم في معركة ضد التخلف.
فالمشكل الهام والمطروح في المرحلة الحالية هو أن يعاد الشخص قيمته واعتباره وإحياء القيم الخلقية والروحية الأساسية الإسلامية من جديد، وأن يضمن احترام حقوقة الشرعية قبل كل شيء، وعلاوة على حقه في حياة كريمة يتوفر فيها الغذاء واللباس والسكن والتعليم والعلاج، له الحق أيضا في الشورى وهو حق لكل مواطن ليبدي رأيه فيما يخص تسيير الشؤون العامة، ويسدي انتقاداته لكل من بيده جزء من الحكم أو السلطة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وينبغي للسلطة من جهتها أن تجري مشاورات حقيقية وحرة في أمور الدولة علىمختلف المستويات لأنه بدون مشاورات ترى ماذا سيبقى؟ أهو العنف؟ وليس هذا بالمرغوب فيه، فهو بعيد على أن يأتي بحل للأمراض التي نحن نهاني منها ونتألم من شدتها.
فنحن أمام مشاكل واسعة ومعقدة يصعب القيام بحلولها دون مشاركة الجميع. وحسب رأينا فإنه يتعين على الحكومة، بعد إصدار العفو على المعتقلين أو المتابعين بسبب أفكارهم، أن تتخذ إجراءات محسوسة وملموسة تؤدي إلى حوار مثمر ومشاورات واسعة النطاق لدى كل من كانت له كفاءة في المجال الاقتصادي أو التكنولوجي أو الديني إلخ…، أو كونه قام بأداء واجبه تجاه الأمة، وبتظافر مجهوداتالجميع يتسنى لنا أن نبحث عن إيجاد أسلوب سليم يمكننا من ربح معركة التنمية، هذه المعركة التي يكون للعقيدة الإسلامية فيها دورها الأول والفعال، مثلما جعلتنا ننتصر على الاستعمار. فهي الكفيل الوحيد الذي يجمع الطاقات ويجندها في سبيل تحقيق هذه الهدف النبيل.
هذا وفي الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى الثلاثين لفاتح نوفمبر 1954 ونمجد معركة التحرير ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذي كانوا الصانعين الرئيسيين للمعركة، وعلى كل واحد منا، خاصة أولئك الذين بيدهم مقاليد الحكم، أن نفكر جيمعا في أفضل منهج يحقق لنا المثل الأعلى الذي تركوه لنا أمانة مسجلة في بيان فاتح نوفمبر 1954، ألا وهو :
تكوين « دولة جزائرية ذات سيادة ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية ».
نسأل الله العلي القدير أن يهدينا سواء السبيل، ويعيننا على الوفاء لأرواح شهدائنا، ويغفر لنا خطايانا وزلاتنا، إنه سميع مجيب الدعاء.
في 1 نوفمبر 1984.