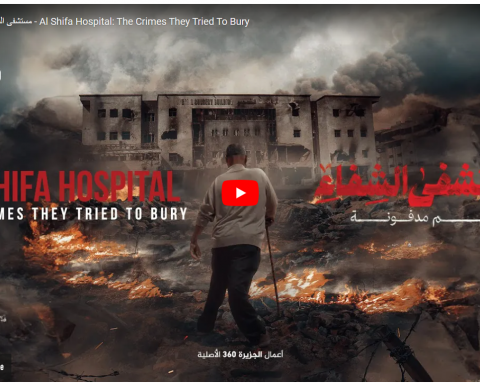مجيد بنشيخ* 02 في 02 جوان 2021
ككل مرة حين يريدون إضفاء صبغة ديمقراطية على النظام السياسي السلطوي، الذي يحاولون بكل جهدهم أن يساندوه، ويحافظوا عليه، يعلن حكام الجزائر عن تنظيم انتخابات، يصفونها بأنها ستكون «حرة ونزيهة».
ولا يهمهم البتة أن انتخاباتهم لم تفد يوما في طرح، أو بالأحرى المساهمة في حل مشاكل الشعب.. كل من يتابع ويرصد ويحلل بطريقة موضوعية الساحة السياسية، يعرف أن انتخابات الجزائر، تساهم أكثر في ضبط وتسوية امتيازات الزبونية، وعلائق القوة داخل النظام، ولا تبلور هيئات مؤسساتية قادرة على تلبية تطلعات المواطن. لقد تسبب رفض حق الجزائريين في التعبير عن رأيهم بحرية، في عواقب وخيمة معروفة، منذ مدة طويلة.
إن لاشرعية النظام السياسي، الذي فرضته القيادة العسكرية منذ 1962 ما فتئت تتدهور، فتسيير موارد البلد من طرف هيئات لا تمثل إلا نفسها، شجّع على السطو والفساد لصالح مجموعات صغيرة تحوم حول المسؤولين، بينما شرائح واسعة من الشعب تعيش حالات صعبة، وتعاني من التهميش يوما بعد يوم، هذه الحالة المزرية لم تترك أمام الشبيبة الجزائرية إلا خيار المناهضة، أو الهروب إلى الخارج. إن انتفاضة الشعب الجزائري منذ فبراير 2019، عرّت النظام السياسي، وبينت أن وراء الخطابات، وبنود الدستور ذات المظهر الديمقراطي، هناك قيادة عسكرية تمارس هيمنة قوية على أهم المؤسسات في البلاد، منذ 1962. ولهذا السبب، ينادي الشعب في كل مكان ويعلن رفضه للنظام السياسي العسكري، ويطالب بسيادة القانون ودولة ديمقراطية مدنية، لا تصدر أمرا لتعلن فيه أن الانتخابات ستكون حرة. حرية الانتخابات نتحقق منها في الميدان، بالممارسة السياسية، وعليها أن تكون مضمونة قانونيا ودستوريا. ويجب أيضا أن تمارس من طرف كل القوى السياسية، بكل حرية. من هذا المنظور، تشكل الانتخابات لحظة حاسمة في الحياة الديمقراطية، لا يمكننا أن نتحدث عن انتخابات حرة، بغياب النسيج الديمقراطي بمكوناته الحزبية والنقابية والجمعوية المستقلة، التي تمثل الشعب، وبغياب نقاشات منظمة، تحترم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية. نزاهة الانتخابات مرتبطة بديهيا بالحرية، تستمد منها قوتها في ظرف مراقبة تنظيمها. من أجل أن تتحقق هذه الانتخابات الحرة والنزيهة، من الضروري أن نتأكد من سيرورتها داخل الإطار الديمقراطي المتعارف عليه.
إذا نحن وثقنا بخطابات الحكام، فإجراء الانتخابات الجزائرية كان دوما يحترم الحريات الديمقراطية، حتى إن كان هذا تحت إمرة الحزب الواحد، وخطاب الحكومة التفخيمي في هذا المضمار يزيد من تأكيده، منذ إقرار دستور فبراير 1989 بالتعددية الحزبية والجمعوية والنقابية، ويتأكد للجزائريين بعدها ميدانيا، بأنها ليست فقط التمثيلية الحزبية، وتمثيلية كل المنظمات التي تعضد السلطة السياسية، بل في توجه المنخرطين في هذه الهيئات إلى الحكام ذوي الحظوة الأكبر. فتبدو الأمور كما لو أن النواب هم في خدمة أصحاب السلطة وزبائنهم أكثر مما هم في خدمة المواطنين. وحسب وجهة نظر المواطنين لم يعد النواب والأحزاب والمنظمات التي ينتمون إليها يحظون بالمصداقية، وعليه فلا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يلعبوا دور الوسيط الضروري في التسيير العادي والطبيعي للهيئة الاجتماعية. ولا يستطيعون أن يكونوا من يتكلم باسم المواطنين ولا إيصال تطلعاتهم. بالنسبة للمواطنين يبدو الأمر كما لو أن الانتخابات لا تخص إلا فئة معينة من الناس، أي ذوي السلطة وأقرباءهم.
في واقع الأمر، انعدام تمثيلية الأحزاب مرتبط بصفة وطيدة بطبيعة النظام السياسي المتسلطة. في هذا النظام، الذي تبوأ سدة الحكم سنة 1962 واستقوى من حينها، القيادة العسكرية هي التي تتحكم فيه وتسيطر عليه. القيادة العسكرية، ومنذ 1963، اختارت كل رؤساء الدولة بدون أي استثناء، وعملت على التصويت عليهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهذا الوضع يبين أن رئيس الحكومة هو الحلقة المفصلية التي تسمح، نظرا للسلطات المخولة إليه، بالتحكم في كل الإدارات، وما نسميه بالتسيير الرسمي للبلاد. وهكذا نرى أنه إذا بقي هذا النظام السياسي الإداري على ما هو عليه، فلا يمكن للانتخابات أن تغير شيئا، وإنما ستلعب الانتخابات الدور المنوط بها، والمقرر لها، من طرف سدنة النظام. فالإدارات تلعب نوعا ما دور المنفذ الثانوي لتوجيهات من يقرر، وتساهم في جعل الهيئات الحكومية أدوات تقمع المواطنين عوض القيام بخدمتهم. يستعمل هذا النظام ورقة التعددية الحزبية المتحكم فيها للتمويه وللخداع، ويسمح بوجود بعض الأحزاب والجمعيات، التي تتمتع باستقلالية نسبية، وتستطيع نوعا ما أن تنتقد الحكام، بمواجهة صعوبات عدة، وفي إطار محدود ومحدد. فيتباهى النظام بهذا الهامش المتاح للمعارضة، ليؤكد على احترامه للحريات الديمقراطية، ولكن في الحقيقة، أغلبية الأحزاب والعديد من الجمعيات والنقابات، تُنشأ وتُسيّر ضمن علاقة وطيدة مع المؤسسة السياسية العسكرية. وبالفعل، هذه المؤسسة التي حملت في البداية اسم «الأمن العسكري» حملت مسميات مختلفة في ما بعد، وعرفت تطورات كبيرة. وبحكم الصلاحيات الرسمية المتنوعة المخولة لها، في ما يخص الشرطة والأمن الداخلي والخارجي، فهي تلعب أيضا دور المتحكم في حياة البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه هي الرقيب الذي يترصد الأخبار، ويتجسس عليها، والموجه الذي يحفّز ويحدد الأهداف، وبما أن هذا النوع من التصرفات مخل ببنود الدستور، فتكتنفه السرية، ووجود هذا الرقيب على الحياة السياسية لا تعترف به الحكومة، ولا تتحمل مسؤوليته، وهكذا يكون كل العمل في ظل سرية منظمة، تستعمل كل المناورات وطرق الخداع، وتنخر الحياة السياسية لتتعطل بذلك كل الأحكام الدستورية والتشريعية، فلا يمكن لأي انتخابات أن تعبر عن تطلعات الشعب في ظل هذه الظروف، التي تشكل عائقا واضحا لتحقيقها.
الآليات الديمقراطية التي ينص عليها الدستور، ويُفتخر بها في الخطابات الرسمية، تتهاوى حين يتوجس الحكام خيفة من التعبئة الشعبية
إن الآليات الديمقراطية التي ينص عليها الدستور، والتي يُفتخر بها في الخطابات الرسمية، ما هي إلا واجهة تتهاوى بمجرد أن يتوجس الحكام خيفة من التعبئة الشعبية، أو أي حدث يمكنه أن يهدد النظام، حينها تتدخل القيادة العسكرية مباشرة في الحياة السياسية، لتلغي الانتخابات، وتقصي كل من يعارض رؤيتها للاستقرار ولمصلحة البلد، سواء أكان المعارض رئيس حكومة أو أي مسؤول آخر. فهذا النوع من التدخلات إلى غاية اليوم هو الذي يسم قرارات السلطة الحاكمة.
حاليا يعيش البلد تحت وطأة انتفاضة شعبية قوية، تعبئ شرائح واسعة من المجتمع ضد النظام السياسي العسكري، وتطالب بإنشاء دولة تخضع للقانون، وتكون مدنية وديمقراطية. يظن الحكام أنهم يستطيعون التمويه حين يستعملون ورقة الانتخابات، علما أن الكل يستطيع رصد، أن الشروط الأساسية، التي يحتمها علينا مفهوم حرية الانتخابات غير متوفرة حاليا، فالقضاء لا يزال يخضع لأوامر تصله عبر الهاتف كما نقول في الجزائر، وأكثر من هذا، فإن المظاهرات السلمية التي تنادي بقيام دولة القانون والديمقراطية، تتعرض للقمع وعدد من متظاهري أو مساندي الحراك الشعبي يُلقى القبض عليهم اعتباطيا كل أسبوع. كيف لنا إذن أن نتحدث عن انتخابات حرة!
في هذه الحالة، لا يمكننا أن نأمل في أن تنظم انتخابات نزيهة، وكما أن حرية الانتخابات لا يؤمر بها، فكذا هو الحال بالنسبة لنزاهتها، حرية الانتخابات ونزاهتها نتحقق منها على أرض الواقع، وبما أن الشعب يعارض مصداقية وشرعية النظام الحاكم وممثليه، فلا يمكن لهذا النظام المرفوض أن يكون المتبني لتنظيم الاقتراع. ولهذا والأمر على ما هو عليه، وجب ألا يتولى المقيمون على الإدارات أو القضاة أو الموظفون المعتمدون لدى هذا النظام مسؤولية اقتطاع الدوائر الانتخابية، تحديد لائحة الناخبين والتحقق منها ونشرها. لا يمكنه أيضا أن يرسل بطاقات التصويت ولا مراقبة والتأكد من صناديق الاقتراع، ولا حتى المشاركة في عد وفرز أصوات الناخبين. فكل آليات الاقتراع السالفة الذكر تساهم في تحديد نزاهة الانتخابات، إن هي وضعت تحت إشراف أيد أمينة. غير أن التحضير الحالي للانتخابات لا يمت بصلة إلى هذا، لا شيء يسمح بتحضير انتخابات نزيهة تعتمد على مساهمة المواطنين في مراقبة مختلف العمليات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والتحقق الفعلي من نزاهتها.
خلاصة القول، إن تنظيم الانتخابات في الثاني عشر من يونيو 2021 من طرف نظام سياسي لا تعكس أي من مؤسساته إرادة الشعب، عوض أن يكون حلا سياسيا تنص عليه دولة القانون المدني والديمقراطي، فهو بالعكس يؤجج الأزمة السياسية التي يعيشها البلد. وحدها مرحلة انتقالية ديمقراطية يمكنها أن تسمح للبلد أن يتخطى هذا الطريق المسدود، الذي انتهجته السلطة لتخنق البلد. يمكن لهذه المرحلة الانتقالية أن تنفذ لو أدرك ذوو السلطة مخاطر هذا الطريق المسدود على البلد. هذه المرحلة يمكنها أن ترى النور إثر مفاوضات جدية بين الحكام وممثلي الحراك الشعبي السلمي، لكي يُؤسس لهيئات مستقلة تكون مهمتها أن تضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية. فتُرسي سريعا إصلاحات تمنح المواطنين الثقة من جديد في الشأن السياسي. هذه هي الشروط التي تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لتشكل تقدما نحو تحقيق تطلعات الشعب نحو الحرية والتنمية.
(*) عميد سابق لكلية الحقوق في الجزائر